يمكنك التواصل مع إدارة الموقع عبر البريد الالكتروني: [email protected]
من هم العلويون؟
الطائفة العلوية هي طائفة فلسفية وروحية عميقة الجذور، وهي طائفة تشمل عقائدها كل ما انزل على اليهودية والمسيحية والإسلامية وترتكز في صلبها على فهم الفلاسفة اليونانيين القدماء مثل ثاليس وأفلاطون وأرسطو وسقراط وغيرهم، ولا تقتصر على الأديان السماوية فهي تبجّل جميع الفلاسفة والعلماء حول العالم مثل الزرادشتية والبوذية وغيرهم.
العلم هو في المرتبة العليا من القداسة للعلويين وتحديداً العلوم التي ينتفع بها البشر مثل الفيزياء والكيمياء والرياضيات والفلك والفلسفة الوجودية ولا تقوم على تقديس النصوص الدينية وإنما على الفهم العميق والتحليل المنطقي لما يتوافق بين العلوم والدين.
العلوية هي نسيج معرفي وروحي فريد، يأخذ من كل مذهب عقائدي أو فلسفي نبضه وروحه، ويعطي للعلم مكانة عليا مضمونها الفهم والتحليل المنطقي لا العبادة الصماء. أقدموا على صياغة رؤية شاملة للعالم، مندمجة بين العقل والنقل، تتقبل الاختلاف العرقي واللغوي والثقافي، وتؤمن بأن البحث عن الحقيقة لا يكتمل إلا بالإمعان في دراسة الكون والذات معاً.
لا يوجد لدى الطائفة العلوية طقوس دينية مقدسة وتعتبر الطقوس قشوراً مكملة للجوهر المعرفي وليست بديلاً عنه ولا يمكن أن تقتصر التعاليم الدينية على الطقوس فقط، حيث يبقى للجانب العلمي والروحي المساحة الأكثر قداسة لديهم.
1. الجذور التاريخية
ترتبط أصول العلويين بأقطار مأهولة منذ آلاف السنين امتداداً من سهل حضر موت جنوب الجزيرة العربية وحتى جبال الأنطاكية في شمال سوريا وجبال سنجار في شمال العراق. وجذورهم – بغضِّ النظر عن تعدّد أعراقهم – ضاربة في عمق الثقافة السريانية:
- التقويم السرياني: يعتمدون على ما يُعرف بـ«سنة خلق العالم» السريانية، والتي اليوم في 2025 ميلادية تقابل العام 6775 حسب هذا التقويم، ويحتفلون بمناسباته ويدونون تواريخهم بين صفحات المخطوطات.
- اللغة واللفظ: أبقى الكثير منهم على مفردات السريانية والآرامية في لهجتهم اليومية، وهي اللغة التي تحدث بها السيد المسيح.
الجذور الحضارية العريقة
- حضارة أوغاريت (في رأس شمرة شمال سوريا)، حيث وُجدت أقدم الألواح المسمارية التي تناولت الآلهة والطقوس.
- البابلية والآشورية في بلاد الرافدين، مع قصص الخلق والحكم التي صيغت فيها القوانين الأولى.
- الفينيقية على الساحل السوري واللبناني، حيث برع الفينيقيون في الملاحة وابتكار الأبجدية.
- اليونانية القديمة الممتدة من أثينا مروراً بالساحل السوري وصولاً إلى الساحل المصري في الإسكندرية، حيث أسس الفلاسفة مثل سقراط وأفلاطون وأرسطو أسس المنطق والبحث العقلي.
خليط الأعراق واللغات
- معظم العلويين من أصول سريانية تكلموا اللهجة السريانية الغربية والتي تعرف بالآرامية ولا تزال أسماء القرى العلوية باللغة السريانية وليس لها أي أصول في اللغات الأخرى.
- آخرون من أصول كردية من منطقة سنجار.
- فئة ثالثة من العرب الغساسنة مثل الفيلسوف عماد الدين الغساني، وغيرهم الذين استقروا في المنطقة قبل الإسلام مثل جبلّة بن الأيهم.
2. المنهج العلمي في قدسيتهم
يرفع العلويون العلم إلى مصافّ العبادة:
- العلوم التطبيقية: الفيزياء التي تفكّ شفرات الكون، والكيمياء التي تكشف أسرار التفاعلات، والرياضيات التي تضبط قوانين الطبيعة، والفلك الذي يرصد حركات الأجرام…
- الفلسفة الوجودية: تتناول علاقة الإنسان بالكون والغيب، وتولي أهمية للبحث الذاتي والتأمّل العقلي.
لا يقدّسون النصوص الدينية شكلياً، بل يتحرّون منطقَها وعلاقتها بالعلم والواقع.
3. العلاقة مع الطقوس
يعتبرون الطقوس قشوراً ثانوية تكمل الجوهر المعرفي، وليست بديلاً عنه:
- لا يوجد لديهم مناجاة جماعية ثابتة.
- قد يُستخدم الماء أو الشموع أو الموسيقى كرموز تساعد على التركيز الذهني والروحي، لكنهم لا يرون فيها غاية بحد ذاتها، بل وسيلة للاسترخاء والتأمّل.
4. روح التسامح والانفتاح
لم يقتصر احترامهم على التراث اليوناني والسرياني فقط، بل يرحّبون بالفلسفات الكبرى:
- الزرادشتية في ثنائية الخير والشر،
- البوذية في فكرة اللاعنف والتأمّل،
- الهندوسية في مفهوم وحدة الوجود.
يجمعون هذه المعارف مع التراث الإبراهيمي ليبنوا رؤية شاملة للعالم والإنسان.
ينظرون إلى جميع المعارف الحضارية كـ«انعكاس لإرادة العقل الإنساني» و«سبيل لفهم أعمق للهُوية والكون».
بماذا يؤمن العلويون؟
يؤمن العلويون بالإله الواحد وبجميع الأنبياء والرسل والملائكة والرسالات النبيلة التي تدعو إلى الفضيلة والأخلاق والعدل.
يؤمنون بأن البشر جميعاً سواسية في الخلق ولكن تختلف المراتب البشرية بحسب المعارف والعلوم النافعة التي يكتسبها الإنسان خلال حياته ويثري فيها مجتمعه.
ما هي نظرة العلويين للمسيحية واليهودية؟
1. التوحيد ووحدة الرسالات
يعلّم العلويون أن الرسالات السماوية (اليهودية، المسيحية، والإسلام) انبثقت كلها من نبعٍ واحدٍ، وهو دعوة إبراهيم إلى التوحيد.
- الجوهر واحد: الرسالة المركزية هي عبادة إلهٍ واحدٍ، وتحريم الشرك والأوثان.
- الاختلاف طقوسي: يختلف اليهود في قراءة التوراة، والمسيحيون في سر التناول والصليب، والمسلمون في الصلوات الخمس والحج، لكن كلّ ذلك – عند العلويين – لا يمس صميم الإيمان.
2. موقفهم من اليهودية
- يرون في التوراة كتاب هدايةٍ أولية امتدّت على ألسنة الأنبياء: نوح، إبراهيم، موسى عليهم السلام.
- احترامٌ كامل للنبي موسى كشخصيةٍ محورية في توحيد اليهودية، واستلهامٌ من فكره حول العدالة والقانون.
- يؤمنون بأن المعاني الباطنية لبعض قصص التوراة تكمّلها دراسات الفلسفة والمنطق، فلا يكتفون بالتأويل الحرفي بل يبحثون عن الحكمة الأعمق.
3. موقفهم من المسيحية
- يجلّ ويقدّس العلويون المسيح ويعتبرونه تجسيداً للقدرات الإلهية ولا يوازي قدسية المسيح أحد آخر لدى العلويين.
- اللغة السريانية تحتل عندهم قيمةً عالية، لأن المسيح تحدث بها، فتقرأ بعض النصوص الإنجيلية في طقوسهم.
- يحتفون بـ عيد الميلاد (الكريسماس) و إحياء ذكرى بعض القديسين مثل مار جرجس والقديسة بربارة والعديد من المناسبات المسيحية.
4. رؤية العلويين للنبي محمد
- يعتبرون النبي محمد رسول الإسلام امتداداً للتوحيد نفسه، لا مُبدِعاً لعقيدةٍ جديدة، بل متمِّمًا لمن سبقوه من أنبياء.
- جاء محمد خاصةً للشعوب الوثنية في الجزيرة العربية، فلم تكن معارف التوحيد قد وصلتهم كما في بلاد الشام.
- يربطون بين تعاليمه وتعاليم موسى وعيسى، ويُفسّرون اختلاف الشريعة بشروط زمانية ومكانية، لا في الثوابت الإيمانية.
5. الطقوس مقابل الجوهر
- الطقوس الدينية (الصلاة، الصوم، وغيرها…) يرونها أدواتٍ مساعدة للصلة بالله، ولا يقدّسونها فوق الحكمة العقلية.
- التأليف العقلي أهمّ: القراءة التأملية، البحث الفلسفي، الربط المنطقي بين النص والتطبيق.
- يرفضون حصر الدين في الشعائر الشكلية، ويؤكدون أنَّ العلم والفكر هما سبيل المعرفة الحقيقية.
6. الصراع سياسي لا ديني
يفسرون أنَّ الخلافات والشروخ التي حدثت بين أتباع الديانات الثلاث لم تكن في جوهر الإيمان، بل صراعات سياسية واجتماعية:
- إدارة السلطة
- توزيع الثروات
- المصالح القبلية والقومية
لذا يدعون إلى الوئام والتعايش بين أتباع التوحيد على اختلاف مذاهبهم، لأنّهم يؤمنون بأنّ الله لا يُقيم للعقلاء حواجز.
العلويون بموقفهم يجسدون روح التسامح والانفتاح؛ حيث يرون في التعاليم الإبراهيمية خطاً واحداً ممتداً عبر اليهودية والمسيحية والإسلام، ويقدّرون كل نبيٍّ وحركةٍ دينية كجزءٍ من مشوار البحث عن الحقيقة، رافضين أن تُحمّل الطقوس والاختلافات الشكلية أكثر من حجمها في القلب المعرفي والروحي.
ما هي نظرة العلويين للفتوحات الإسلامية؟
١. الفتوحات كظاهرة تاريخية
يرى العلويون أن الفتوحات الإسلامية التي امتدت من الجزيرة العربية إلى الشام وشمال إفريقيا كانت – في جوهرها – حركة سياسية، وليست رسالة دينية تلزم الرعية على الدخول في الإسلام قسراً. فالمسلمون الأوائل، إنما سعوا لبناء مجتمع مدني، ونشر الأمن والاستقرار، لا لإكراه الشعوب على تغيير عقائدهم.
٢. مبدأ الإرادة الحرة
- يؤمن العلويون بقوةٍ بأن إرادة الإنسان حرة، وأن لكلِّ فردٍ فلسفته وطريقته في السعي إلى النور الإلهي.
- تستمد هذه القناعة من فهمهم العميق لمبادئ التوحيد ومعنى الاختبار، حيث لا يصح أن يُطلب من الإنسان شيءٌ يخالف اختياره أو يملي عليه عقيدة معينة بالقوة.
٣. حرمة الإكراه في الدين
- يقتبس العلويون قوله تعالى: «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ» (سورة البقرة: 256)
- يفسرونها تفسيراً روحانياً ومعرفياً: أن قبول الدين لا يتم إلا برضاءٍ داخلي وفهمٍ عقلاني، وليس بالطاعة الشكلية تحت التهديد أو الجزاء.
٤. الانفصال بين الدين والسياسة
- يفرِّق العلويون بين مهمة الرسالة التي يكلف فيها الأنبياء بدعوة الناس إلى العبادة، وبين السلطة السياسية التي تولت تشغيل آلة الفتوحات بعد عهد النبي.
- يعتقدون أن استخدام الدين كرافعة للغزو أو التوسّع كان انحرافاً عن الهدف الأصلي: نشر السلم والرحمة.
٥. الدروس العلوية للأجيال
حق المجتمعات: الحفاظ على ثقافاتهم ولغاتهم وتاريخهم، حتى في ظل بناء الدول الكبرى.
التسامح الديني: احترام معتقدات الآخر وحقه في الاختيار.
النهج العقلاني: استظهار الأدلة والحجج قبل الاقتناع بأي فكرة.
ما هي أماكن تواجد العلويين؟
لأن العلويين طائفة روحية توحيدية، عاصرت الرسالات السماوية كلها فأضافت لهم وأضافو لها دون أن تمس إحداهما الأخرى، لأن الجوهر واحد وهو التوحيد.
يتركز العلويون في بلاد الشام خاصة في سوريا الطبيعية (سوريا، لبنان، تركيا)، وبسبب تعرضهم للاضطهاد عبر السنين، فكانت الهجرة ملاذاً لهم، فانتشرو بسببها في أنحاء العالم، واندمجو في المجتمعات بسهولة بسبب طبيعتهم المتقبلة والمنفتحة على الآخر.
كانت أكبر الهجرات في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، فكان من أبرز الوجهات التي هاجروا إليها هي الأرجنتين والبرازيل واستراليا.
عليّ بن أبي طالب: عالمُ لغةٍ وفيلسوفٌ وقاضٍ — بوابةُ مدينةِ العلم
من وجهة النظر العلوية، تبدأ حكاية عليّ ليس كخليفةٍ أو رجلِ دولةٍ، بل كـ عالمِ لغةٍ وفيلسوفٍ وقاضٍ؛ رجلٍ جمع بين البلاغة والمنطق والعدل، وصاغ مشروعًا فكريًّا ما زال يشعُّ حتى اليوم.
1. من البلاغة إلى الفلسفة
يُنسب إلى عليّ إحكامُ أسرار اللغة العربية كما يُنسب لأرسطو إحكامُ المنطق اليوناني. خطبُه وأقوالُه تُتداول في الحلقات العلوية بوصفها نماذج لغويّة تُعلِّم كيفية تحويل الكلمة إلى أداةٍ لفكِّ ألغاز الوجود. هذا الشغف باللغة كان، عند العلويين، بوابةً إلى فلسفةٍ أعمق تسأل عن «معنى المعنى» لا عن ظاهر اللفظ فقط.
2. بوابةُ مدينةِ العلم
يُلقَّب عليّ بـ «باب مدينة العلم»؛ أي إنّ كلَّ رحلةٍ إلى الحكمة الباطنية تمرُّ به. في هذا التمثّل يتقاطع عليّ مع صورة الحكيم–المُرشد في التراثَين السرياني واليوناني: يحمل شعلةَ المعرفة ليعبر بها التلاميذ من ظلمات النقل الحرفي إلى نورِ البرهان العقلي.
3. النور والسرّ
العلويون يتعاملون مع عليّ بوصفه حامِلًا لـ «نورٍ أزلي» سابقٍ للمادة. هذا النور ليس «كرامةً» بالمعنى التقليدي، بل طاقةُ فهمٍ قادرة على كشف العلاقات الخفيّة بين الإنسان والكون. لذا تُروى عنه أحاديث تتناول تأمّلاته في حركة الأفلاك، و«سرّ الحرف» الذي يربط اللغة بالوجود.
4. تأسيسُ الحلقات والمدارس
مع أبنائه وأحفاده الاثنَي عشر، أطلق عليّ شبكةً من الحلقات العلنيّة والمدارس السرّية في الكوفة والشام وحلب. هناك دُرّست الفلسفة اليونانية، وجُمعت مخطوطات السريان، وتلاقحت الرياضيات الهندية بالخوارزميات العربية. هذه المدارس شكّلت نواةَ ازدهارٍ علميٍّ، وأثمر طِبًّا وفلكًا وهندسة.
5. القاضي العادل ومنهجه العقلي
حين تولّى القضاء، مزج عليّ بين رؤى بابل القانونية وروح الفلسفة الأخلاقية. يُستشهَد بأحكامه لدى العلويين كأمثولةٍ لـ العدل المنهجي: حكمٌ لا يخضع لقوة سلطان ولا لهوى جمهور، بل لمعيارٍ عقليٍّ يتتبّع سبب الظلم وجذورَه ليقتلعها.
6. العصمة بوصفها كمالًا فكريًّا
فكرة العصمة هنا ليست حصانةً من الخطأ في الفقه فحسب؛ إنها كمالٌ في القدرة على التمييز بين حجةٍ صادقة وزيفٍ مُقنّع. لذلك يُقدَّم عليّ نموذجًا لمن يستخدم العقل تحريرًا لا تسليمًا، فيدفع أتباعه إلى الشك النبيل قبل التصديق.
7. إرثٌ يتجاوز الأزمنة
بقي منهجه يرفد الحركات العلمية عبر العصور: خريجو المدارس العلوية نقلوا المنطق إلى بيوت الحكمة، وأشعلوا شرارة النهضة، وأسّسوا حوارًا مع الفلسفة اللاتينية لاحقًا. في كلِّ محطة يظهر عليّ كـ رمزٍ لعقلٍ لا يَرتهنُ لعصرٍ ولا لمذهبٍ.
المدرسة العلويّة في العصر الذهبي: شبكةُ العلم التي رفدت كلَّ مجال
يَجتمع عند المدرسة العلويّة- بوصفها الامتداد الأعلى لبوّابة «مدينة العلم» التي فتحها الإمام عليّ بن أبي طالب – إرثٌ فكريٌّ هائل تجاوز الحدود المذهبيّة والجغرافيّة. وفيما يلي خلاصةٌ موحَّدة لأعلام ذلك العصر كما تحفظهم الرواية العلويّة، مرتَّبين بحسب ميادينهم التخصصيّة، مع الإشارة إلى أنّهم إما من نسل الأئمة أو من تلامذة تلامذتهم أو من المنتسبين فكريّاً إلى منهجهم العقليّ.
1. الطبّ والصيدلة
- جابر بن حيّان – «أبو الكيمياء» ومؤسِّس علم السموم والتشريح التجريبي.
- عليّ بن العبّاس الأهوازي – صاحب كامل الصناعة الطبية.
- أبو بكر الرازي – مبتكر تقسيم الأمراض وأوّل مَن فرّق بين الجدري والحصبة.
- ابن سينا – واضع القانون في الطب ومطوّر مفهوم العدوى.
- الزهراوي – رائد الجراحة والأدوات الجراحيّة الدقيقة.
- ابن النفيس – مكتشف الدورة الدمويّة الصغرى.
2. الفيزياء والبصريات
- الحسن بن الهيثم – مهندس المنهج التجريبي وصاحب كتاب المناظر.
- أبو الريحان البيروني – واضع كثافة المعادن وقانون الجاذبيّة النوعيّة.
- نصير الدين الطوسي – مبدع «الثنائي الطوسي» في الحركة النسبيّة وانكسار الضوء.
3. الهندسة والتقنية
- بنو موسى بن شاكر – واضعو كتاب الحيل في الآلات الميكانيكيّة.
- الجزري – مصمّم الساعات المائيّة ومضخّات الزئبق.
- تقيّ الدين الراصد – مخترع التوربين البخاري ومضخّة الأسطوانتين.
4. الكيمياء وعلوم المواد
- جابر بن حيّان (مرّة ثانية لكثرة إسهاماته).
- محمد بن زكريا الكوفي – مطوّر عمليات التقطير والقلوَنة.
- المظفّر بن العلوي – باحث في سبائك الذهب والفضّة.
5. الفلك والرصد
- البَتّاني – محسّن قياس السنة الشمسيّة وزاوية الميل.
- عبد الرحمن الصوفي – مؤلّف صور الكواكب الثابتة.
- عمر الخيّام – مهندس التقويم الجلالي وحاسب المثلثات الكرويّة.
- مرصد المراغة بقيادة الطوسي: خرّج محيي الدين المغربي وقطب الدين الشيرازي.
6. الرياضيات والمنطق
- الخوارزمي – مؤسّس علم الجبر والخوارزميات.
- ثابت بن قُرّة – مترجم إقليدس ومطوّر الهندسة التحليليّة الأولى.
- الكرجي – واضع الفخري في الجبر.
- جَمْشيد الكاشي – محدِّد π بدقّة غير مسبوقة.
7. الفلاسفة والمفكّرون
- الكِندي – أوّل من مزج الفلسفة اليونانيّة بالوحي.
- الفارابي – مبتكر «المدينة الفاضلة» وسلّم العلوم.
- ابن سينا – جامع الميتافيزيقا بالعلوم الطبيعيّة.
- إخوان الصفاء – رسائل موسوعيّة في الرياضيات والروحانيّات.
- ابن باجّة، ابن طفيل، ابن رشد – ثلاثي قرطبة الذي شرح أرسطو وأسس للعقلانيّة الأندلسيّة.
- شهاب الدين السهروردي – صاحب «حكمة الإشراق».
- نصير الدين الطوسي (إسهام فلسفي موازٍ لجهده العلمي).
8. الأدب والشعر
- أبو الطيّب المتنبي – شاعر الذات الحرّة وصائغ الحكم البلاغيّة.
- أبو العلاء المعرّي – صاحب نزعة الشكّ العقليّ والشعر الفلسفيّ.
- البحتري – مُجيد الربط بين التصوير الحسيّ والرؤية العقليّة.
- ابن الفارض – شاعر التجربة الصوفيّة الكونيّة.
- عمر الخيّام – رباعيّاته التي تمزج الخمرة بالأرقام والوجود.
- ابن زيدون – غزله الأندلسي رمزٌ لجمال التوازن بين الحسّ والفكر.
9. علوم الأحياء والجغرافيا
- المسعودي – مؤرّخ وجغرافي مروج الذهب.
- الإدريسي – صاحب الكرة الفضّية وخريطة العالم للصقليّين.
خيطٌ ناظم واحد
بحسب تقليد المدرسة العلويّة، كان الإمام جعفر الصادق حلقةَ الوصل الكبرى التي انتقل عبرها منهجُ البرهان العقلي والتجريب العلمي إلى الأجيال التالية. هكذا بدا كلُّ هؤلاء ــ أطبّاء وفلكيّون ومهندسون وفلاسفة وشعراء ــ حلقاتٍ في عقدٍ واحد، عنوانُه: العقل والنور اللذان استُلهمَا من بوّابة عليّ بن أبي طالب، فأنارا أرجاء الحضارة حتّى أقاصي الأرض.
بعض الشخصيات الهامّة لدى العلويين

الإسكندر واحد من مظاهر النور الإلهيّ عبر التاريخ، يجمع بين الحكمة الروحية والقوّة الماديّة في الحكم العادل.
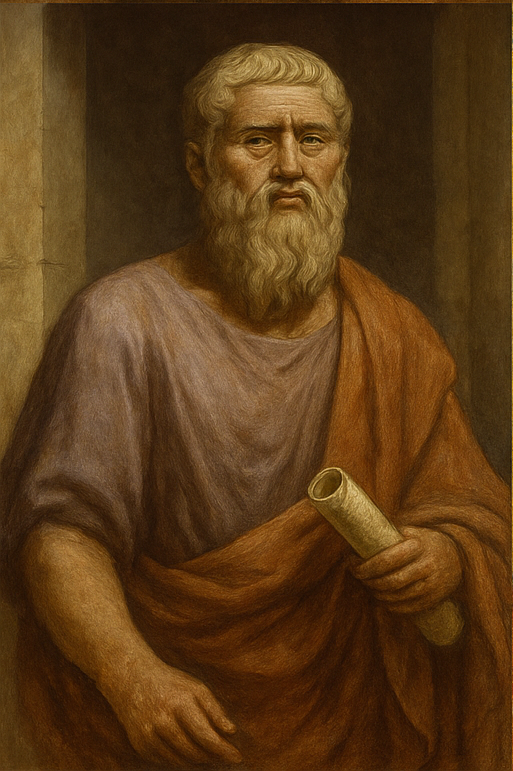
أفلاطون ليس فقط كفيلسوف يونانيّ بل مصدرٍ روحانيّ وفكريّ مُلهم وهو حاكم الفلاسفة.
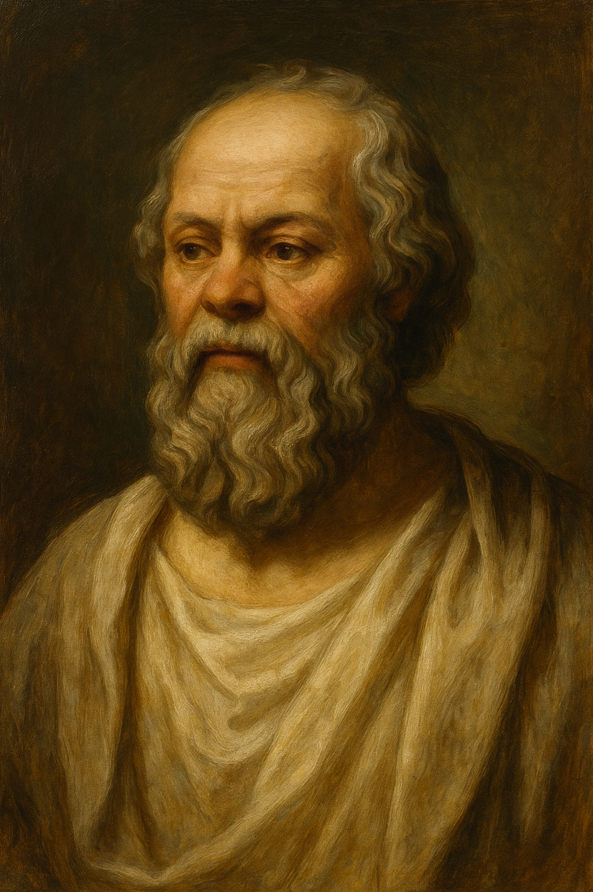
سقراط هو نبراس النزاهة الفكرية.
طبيب يداوي جراح الجهل والمادية.
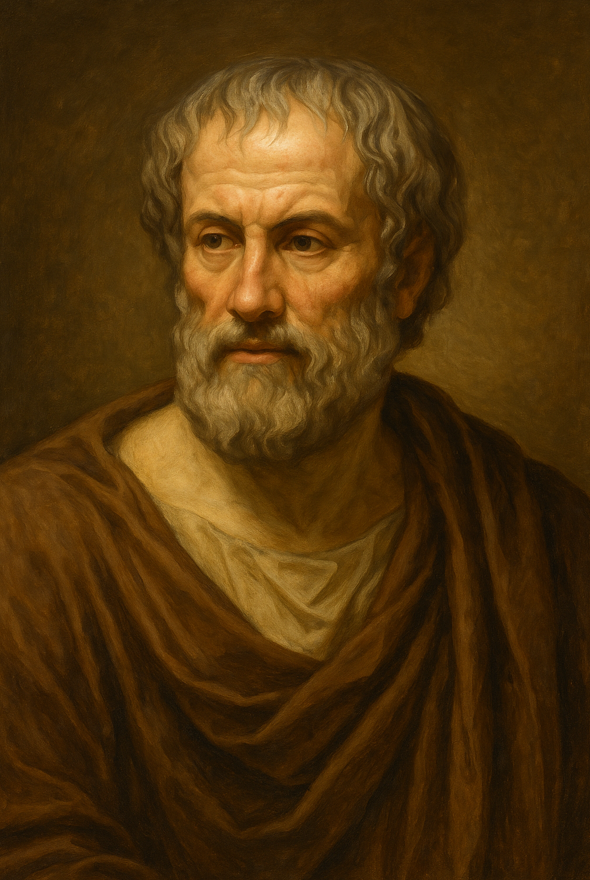
يُبرز أرسطو قيمة المنهج المنطقي والتنظيم العقلي،
لتنقية المعارف من التناقضات.
هو بابٌ لفهم أسرار الكون بهدْي الأدلة العقلية.
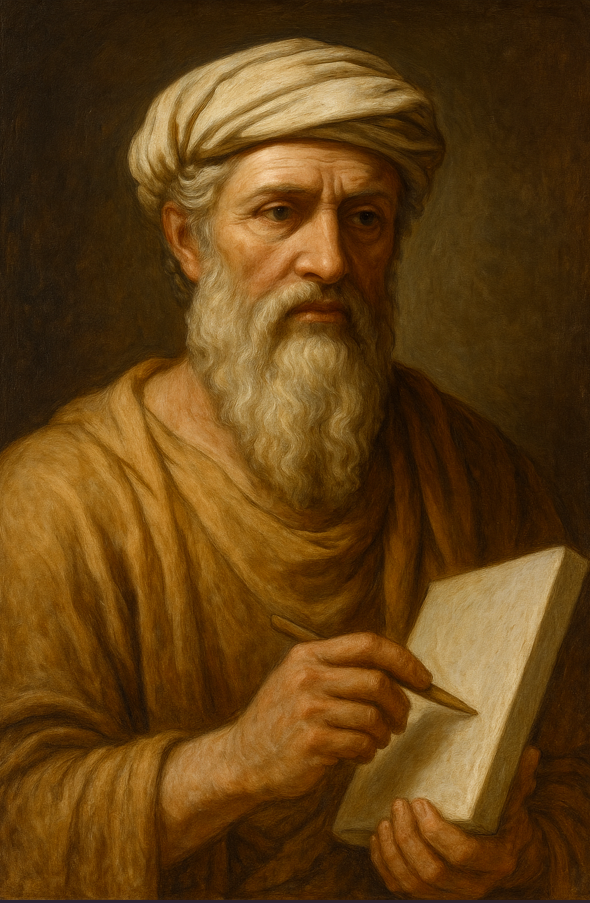
هو أكثر من فيلسوف رياضي، ومبادئه في تناسق الأعداد
رمزاً للوحدة والانسجام الكوني،
وجسراً بين النظرية الرياضية والسر الباطني للنور.
